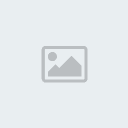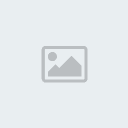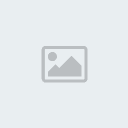ما بعد الملك عبدالله الخلافة في السعودية
اسلام تايمز - طرح «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» قبل عامين من اليوم الملف السعودي عن قرب، وذلك في تقرير أعده الكاتب الأميركي سايمون هندرسون بعنوان «ما بعد الملك عبدالله.. الخلافة في السعودية».
منطلقاً من تاريخ الخلافة في المملكة، المؤثرات التي تلعب دوراً أساسياً في تسمية الخلف، دور هيئة البيعة السعودية وحدود صلاحياتها، الخلافة في صفوف أبناء المؤسس عبد العزيز، الخلافة في صفوف الجيل الجديد (أحفاد المؤسس)، وتأثير العهد الجديد «المنتظر» على العلاقات الأميركية ـ السعودية... أما وقد حسم السعوديون أمـر ولايـة العـهد، باختيار الأمــير نايــف (78 عاماً)، «الرجــل الأصعـب» الذي يعـاني من مرض خبيث في الدم، تعـيد صحيفة «السفـــير» قراءة سطور التــــقرير الأميركي من جـــديد، بعــدما نشــره المعـــهد للمرة الثانية، على ضوء التطورات المستجدة في المملـــكة، أو «المملكات»، إذا جاز التعــبير، نظراً للتفرعات السياسية الداخــلية في الريـاض والتـي توحي بوجـود أكــثر مـن «قـرار» وأكـثر مـن «تيـار».
الخلافة، المرجّح أن تتسارع وتتنقل بين أمراء طاعنين في السن (كل عامين أو ثلاثة)، تحمل ما تحمله من خطورة على الاستقرار السياسي في السعودية وعلى استقرار العلاقة مع واشنطن: الملف الإيراني، الوضع العراقي، مستقبل أفغانستان، العلاقة مع باكستان، مسار السلام في الشرق الأوسط، مكافحة «الإرهاب»، العلاقة مع العالم الإسلامي، أمن الطاقة، المسألة النفطية الجوهرية، استيراد الأسلحة... رزمة ضخمة من الملفات الإقليمية والدولية يبقى للرياض دور أساسي في صياغتها، كما تقلق واشنطن بالذات التي تحاول رغم «تقلبات» الداخل السعودي، أن تسيطر عليها من خلال علاقة «مستقرة ومتشعبة» مع أمراء المملكة وليس مع الملك فقط.
رافق استحقاق تعيين الأمير نايف ولياً جديداً للعهد، كمّ هائل من التساؤلات التي طافت على سطح العلاقة بين الأبناء الـ 18 للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والاحتمالات المواكبة لتولّي كل منهم السلطة بعد الملك عبدالله، الساهر على صحّته أكثر من أي وقت مضى. لماذا الأمير نايف وليس الأمير سلمان؟ لماذا يتولى أبناء المؤسس الخلافة وليس أبناء الأبناء؟ ما الذي يمنع خروج الخلافة من دائرة الجيل الأول الطاعن في السن لتشمل الجيل الثاني، الذي ليس أيضاً في ربيع عمره (محمد بن نايف - 52 عاماً - نموذجاً)؟ ما هي الظروف التي تفرض على المملكة أن تعيش شيخوخة قياداتها؟ إلى أي مدى تقرّر العلاقة مع الولايات المتحدة اسم الخلف؟ ... لا شك في أن عوامل مؤثرة عدة تقررّ شخص الخلف وبالتالي مستقبل السعودية، خصوصا أن الممسكين بالعنصرين المحدّدين لقوة المملكة ونبضها، الإسلام والنفط، هم الأفعل في الداخل: رجال الدين هم أكبر المؤثرين في السياسة الخارجية للمملكة، أما التكنوقراط فيها، فهم المتحكمون بسياستها النفطية.
إذاً، تخضع الخلافة في السعودية لمزاج عام يربط بين العائلي والسياسي والاقتصادي، فيما يرى دبلوماسيون مطلعون «سعودياً» أن «عدد المشاركين في اتخاذ قرار ما في المملكة، من أمراء وشخصيات مهمة، يعتمد على القضية المطروحة»، بمعنى أن المشاورات حول إمكانية إشراك شركات أجنبية في عملية تطوير موارد النفط السعودية تختلف عن المشاورات حول ولاية العهد والخلافة. فيمكن للأولى أن تستوجب بعض المماطلة تماماً كما حدث أواخر التسعينيات، عندما اقترح وليّ العهد الأمير عبد الله دخول أجانب على خط تنمية الموارد النفطية، ليصطدم بمعارضة شركة «أرامكو» للبترول ووزراء النفط السعوديين مدعومين من الملك فهد، الذي طالب بالدعم الأميركي بعد غزو العراق للكويت فيما كان عبد الله وغيره من الأمراء مع خيار التريث لمزيد من الاحتمالات، غير أن سلطة الملك فهد كانت الأقوى. أما الخلافة فلا يمكن إخضاعها لمماطلة مماثلة، أي معالجتها على الطريقة «البدو - قراطية» (على شكل مشاورات في صفوف شيوخ القبيلة تُرفع بعدها إلى كبار القبيلة) خصوصاً أن للخلافة خصوصية دينية، إذ بعد نيل الملك المسمّى رضا الأمراء، يعلنه العلماء إماماً (قائداً مسلماً)، وذلك بناء على فتوى تؤكد شرعية قرار تنصيبه. وهكذا يكون دور العلماء ليس فقط المصادقة على تسمية الملك على أساس ديني بل التأكيد على العلاقة العضوية بين آل سعود والتيار الإسلامي الوهابي في المملكة.
وبالرغم من الاختلاف في أنواع القرارات المتخذة، تبقى سياسة التوافق هي السائدة بحيث تمنع ظهور «انشقاقات» في الواجهة السعودية. فنظام «هيئة البيعة السعودية» مثلاً، الذي أقيم العام 2006 كمقاربة للنهج الإسلامي الموروث وتجسيداً أولياً لصيغة «أهل الحل والعقد»، أول مجلس شورى إسلامي عُرف في مطلع الخلافة الراشدة، هدف لترسيخ القرار التوافقي ضمن العائلة المالكة بحيث تتمثل في الهيئة كل «تيارات» المملكة.
لا تراعي المشاورات الداخلية حول الخلافة رأي الأمراء فحسب بل أيضاً، وعلى خلاف ما يعتقد المتابعون للشؤون السعودية، رأي زوجاتهم وتصوراتهن للمرحلة المقبلة أيضاً.
إذ تلعب نساء آل سعود دوراً سياسياً في الخلافة يتجسد في أساليب ثلاثة:
أولاً، هنّ في الواقع «أرباب» منازلهن، فوراء جدران القصور، يجتهدن في التعبير عن وجهة نظرهن لأزواجهن وأبنائهن بطريقة صريحة.
ثانياً، إن التزاوج ضمن عائلة آل سعود يعني أن تحالفات عدة من الممكن أن تُنسج بين أجنحة العائلة، وذلك وفقاً لمتانة العلاقة التي تقيمها الزوجة مع عائلتها الأولى ومدى «شعبيتها» داخل عائلتها الجديدة.
ثالثاً، إن مشاركتهن فاعلة في اجتماعات «ملكية»: هذا ما كان يحدث على الأقل إبان عهد الملك فهد، حيث كانت اجتماعات متكررة تُعقد مع نساء آل سعود كي يتبادلن مع الملك أفكارهن وتصوراتهن.
قد يصبّ إشراك النساء في القرار، ولو بشكل سري، في الحفاظ على منطق «التوافق» في اتخاذ القرارات، خصوصا أن ما تكرّس في المملكة، منذ 250 عاماً وحتى اليوم، هو تشعّب أذرع الشجرة العائلية حتى وصل عدد من يطلق على نفسه لقب «الأمير» خلال التسعينيات إلى 20 ألفاً، بين «صاحب السمو» و«صاحب السمو الملكي»... (يُذكر أن قادة القبائل السعودية يستخدمون أيضاً لقب «الأمير» لكن من دون الصفات الشرفية).
أوصى مؤسس المملكة بـ«تاريخ ولادة الأبناء» معياراً لخلافته، أي من الأكبر إلى الأصغر سناً، فاتبع الأمراء وصية الوالد محترمين العمر أكثر من أي سمة أخرى لاختيار الملك. فإلى جانب ذلك، تحاول العائلة المالكة، تأطير «الانتخاب» الافتراضي لرأس المملكة بشروط أخرى، أوصى بها أيضاً عبد العزيز آل سعود، أهمها:
أولاً، أن يكون الملك «مسلما صالحا»، أي ألا يشرب الكحول، غير أن هذا الشرط قد يضيّق كثيرا مجال التنافس، لذا تم إلغاؤه من قائمة الشروط.
ثانياً، أن تكون أم الملك سعودية (معظم زوجات المؤسس الـ22 غير عربيات: أم بندر بن عبد العزيز مغربية، أم مقرن يمنية، أم مشعل ومتعب وطلال ونواف أرمنيات.
وهكذا تنحصر الخلافة بين 13 من الأبناء من أصل 20، وذلك قبل وفاة أي منهم).
ثالثاً، أن يكون لدى الملك خبرة في الحكم: في وقت تمتع كثيرون من أبناء عبد العزيز بخبرات «سلطوية» لم يكن لمعظمهم قدرة على الإدارة، وهذا ما يُترجم في عددهم القليل الموجود في مواقع المسؤولية، فإلى جانب الملك عبد الله، ومؤخراً ولي العهد الأمير نايف، تولى متعب وزارة البلديات قبل عامين وعبد الرحمن منصب نائب وزير الدفاع، واحمد نائب وزير الداخلية، وسلمان حاكم الرياض، وسطام نائب حاكم الرياض، ومقرن رئيس جهاز الاستخبارات العامة.
رابعاً، يفضّل وصول ملك «ذكي» بمعنى أن يتحلّى بالحذر والفطنة، غير أن هذه الصفة التي التصقت بالملك فيصل تحديداً، قلّما اتسم بها سواه من الأمراء على الرغم من أنهم يوحون بذلك علناً.
خامساً، أن يكون الملك «شعبياً» و«محبوباً»، وهذا ما يظهر خلال اعتلاء الأمراء رئاسة ما يسمى بـ«المجلس» حيث تُنظّم لقاءات بين الأمير ومواطنين عاديين، يحرص خلالها الأمير على إظهار سخائه بتوزيع الأطباق الشهية.
سادساً، أن يكون الملك «مستقراً» ذهنياً، وهذا ما لم ينطبق على الأمير محمد الذي لطالما كان مدمناً على الخمر والأمير سعد الذي توفي في العام 1993 بعد معاناته من عدم استقرار ذهني لسنوات.
إذاً، يأتي ملك الدولة النفطية على أساس شروط لم يعدّل منها شيء منذ وفاة الملك المؤسس قبل حوالى 60 عاماً، لتلتزم بها «هيئة البيعة السعودية» بدورها، منذ بدء مهامها العام 2006. فالهيئة التي اقترح الملك عبد الله تشكيلها تعنى بتسمية كل من ولي العهد والملك في محاولة لإشراك كل «تيارات» المملكة بقرار الخلافة (35 عضواً). قد يكون ذلك السبب الظاهر، غير أن السبب الضمني الذي يرجحه مقربون من الرياض هو محاولة الملك عبد الله إبعاد «السديريين» (نسبة لأبناء الأميرة حصة بنت أحمد السديري) عن ولاية العهد بعد وفاة الأمير سلطان. غير أن خطة عبد الله باءت بالفشل، إذ تمّ التسويق لاسم الأمير نايف خلفاً لسلطان في آذار 2009، حين اشتد مرض الأخير. أغاظ الإعلان عن ذلك، الأمير طلال تحديداً حيث طالب المملكة بتوضيح الأمر، غير أن صرخته لم تلق صدى... عُيّن الأمير نايف ولياً للعهد قبل أسبوع بسرعة وسهولة أوحتا بأن لا انقسام يُذكر داخل أروقة الأسرة الحاكمة.
إلا أن التعيين أكد أيضاً أن عبد الله لم يستطع التنصل من «السديريين» (من سلطان إلى نايف) رغم مرور التسمية في هيئة البيعة التي لم تجتمع سوى لثلاثين دقيقة قبل أن تخرج مبايعة الأمير نايف، بإيعاز من الملك. وذلك ليس سوى دليل قاطع على عدم استقلال الهيئة عن التجاذبات السعودية الداخلية، بل لكونها ساحة «سرية» لها.
لا يغيب ظلّ الولايات المتحدة عن تجاذبات الداخل، فمسألة الخلافة لا تعدو كونها شأناً سعودياً بحتاً، إذ تقرّر، في الوقت عينه، توجهات المملكة، السياسية والاستراتيجية، تجاه الخصوم كما الحلفاء.. وعلى رأسهم «الحليف الأكبر».
في الحقيقة، لطالما ألقت شخصية الملك وسياساته، على السواء، بظلّها على طبيعة العلاقة الثنائية على خط واشنطن – الرياض. فالملك فهد، الذي حكم بين عامي 1982 و2005 (على الرغم من معاناته من أزمة صحيّة سيئة إثر إصابته بجلطة دماغية بعد العام 1995)، كان موالياً للولايات المتحدة إلى أبعد الحدود، ولم يتوانَ عن التنسيق معها عن كثب في العديد من الملفات المتعلّقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك في أميركا الوسطى وأفغانستان وفي متابعة عمليّة السلام في الشرق الأوسط.
من جهته، وعلى الرغم من حفاظه على النهج ذاته الذي اتبعه سلفه، بدا الملك عبد الله، الذي تربّع على العرش في العام 2005، أكثر تحفظاً وحذراً إزاء واشنطن، حتى في أشد لحظات المواجهة احتداماً. ففي العام 2002، عندما بدأت العلاقة بين البلدين تزداد تعقيداً، بعد الكشف عن تورّط سعوديين في هجمات 11 أيلول، حاولت الرياض الالتفاف على «الفضيحة» وتسليط الضوء على ملف المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مهدّدة بقطع موقت لصادرات النفط عن الولايات المتحدة في حال استمرّت في دعمها للإسرائيليين.
ما سبق من أسباب وغيرها، يفسّر لماذا تشكّل وجهات نظر وشخصيات ملوك السعودية المستقبليين موضع اهتمام شديد في دوائر صنع القرار في واشنطن. صحيح أن شركات النفط الأميركية توفّر الأسس اللازمة لصناعة النفط في المملكة، كما أن مصدّري الأسلحة الأميركيين يدعمون ترسانتها العسكرية، إلا أن العلاقة الثنائية تنطوي على ما يتخطى ملفي الأمن والطاقة بأشواط. يُشار إلى أن ما سبق من تحليل يتجنّب مصدر التوتر الحقيقي في العلاقة: دور الدين في حياة المملكة. وبما أن الإسلام هو السمة المركزية في البلاد والمتحكمة بمختلف تفاصيل حياتها، يصبح الحال: بعيداً عن التوافق العضوي المرتبط بالنفط ومظاهر الأمن، لا تزال المسافة شاسعة بين البلدين بسبب الاختلاف الجذري في وجهات النظر حول قضايا الحريات السياسيّة والتسامح الديني وحقوق المرأة.
أما اليوم، فيثير ولي العهد الجديد الأمير نايف، مخاوف واسعة في أوساط صنع القرار الأميركي، من أن يزيد العلاقات مع السعودية صعوبة وتوتراً. سبب هذه المخاوف، ما يشاع عن صعوبة مراس الأمير الذي، على سبيل المثال، رفض تشديد التدابير الأمنيّة في أيار من العام 2003 قبل هجوم «القاعدة» على مجمّعات الأجانب السكنيّة في الرياض والذي أدّى إلى سقوط تسعة قتلى أميركيين. وسبق أن اتهم الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء هجمات 11 أيلول على برجي التجارة العالميين. وفيما ينظر إليه على أنه محافظ، لا ينفك الأمير نايف يتقرّب من رجال الدين في المملكة ويصرّ على دعمه لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في وقت يرفض بحزم مشاركة المرأة في الحياة السياسية. يُذكر أن الأكثر تحدياً في العلاقة مع نايف، كما مع سلطان، بالنسبة للولايات المتحدة يعود إلى أواخر العام 1990 عندما كان الأميران يغريان أسامة بن لادن مادياً، لتجنّب أي هجمات محتملة للتنظيم داخل المملكة، ما يُفسّر كيف أدى وقف التمويل في العام 2003 إلى الهجوم المعروف على الرياض.
صحيح أن واشنطن تحاول عدم تسمية مرشحها المفضّل للخلافة علنياً، إلا أن الموضوع يُناقش مع السعوديين أنفسهم، الذين يعتقدون أن الضغوط الأميركية يمكن أن تكون فعّالة، ولو لم تكن مباشرة. ففي العام 2003، على سبيل المثال، عبّر سفير الولايات المتحدة لدى الرياض في دائرة مغلقة عن عدم رغبته بوصول الأمير سلطان أو نايف إلى الخلافة، وتطلعه إلى انتقال الأخيرة إلى الجيل الجديد.. وهو ما اعتبر حينها بمثابة تلميح أميركي تلقفته الرياض بحذر لكنه لاقى أصداء تجلّت في الأسئلة التي بدأ يتداولها الملك ومن حوله عن المرشحين المثاليين من الجيل الجديد.
أما في الجيل الحالي، فهناك الأمير سلمان الذي يأتي بالترتيب بعد شقيقه الأمير نايف. ويحظى سلمان، حاكم الرياض حاليا، بقبول في أوساط الدبلوماسيين الغربيين أكثر من غيره، فيما يمتلك شعبيّة كبيرة لدى العائلة المالكة وعامة الشعب. غير أن وضعه الصحي غير مطمئن (اثنان من أولاده توفيا بأزمات قلبيّة)، فضلاً عن أن رؤيته السياسية قد تخيف واشنطن: لقد أعرب أمام السفير الأميركي في أعقاب هجمات 11 أيلول عن اعتقاده بأن الهجوم كان صهيونياً. ومع ذلك يبدو أن اسمه كملك للسعودية يلقى قبولاً في الأوساط الأميركية ومراكز القرار.
في الواقع، أياً تكن هوية الملك المستقبلي فجلّ ما تتمناه واشنطن هو الحفاظ على ذاك الانتعاش الذي حظيت به العلاقة منذ العام 2008. ويُذكر في هذا السياق، أن الملك عبدالله أحرز تقدماً في عهده على مستوى الحوار بين الأديان، وضرب الإسلاميين بيد من حديد. وبفضل ارتفاع أسعار النفط، حظيت المملكة باحتياطيات ماليّة ضخمة، مكّنتها من أن تصبح قوة اقتصادية كبرى في مجموعة العشرين. ومع ذلك لا تزال التحديات قائمة، فآل سعود طلبوا، في السرّ طبعاً، من الولايات المتحدة أن تكون أكثر حزماً في الردّ على إيران التي تطوّر سلاحها النووي. أما في العلن، فموقف السعودية من ملفات إيران والسلام في الشرق الأوسط يبقى ضبابياً.
العراق هو مصدر آخر للتوتر، حيث يثير النفوذ الإيراني هناك قلق الرياض وأميركا على السواء، في وقت تنظر الرياض إلى المجال الأفغانو – باكستاني من منظار مختلف، إذ يشكّل تلويح الرياض بتسهيل تشريع عمل الجهاديين عاملاً حاسماً، كما بحثها عن مصدر بديل للطاقة النووية في باكستان بعيداً عن الولايات المتحدة.
وفي النهاية، لا يمكن اقتصار الحكم على السياسات التي سيتبناها الملك المستقبلي من خلال أدائه السابق قبل توليه المنصب. فعلى سبيل المثال، يمكن وصف موقف الملك عبدالله قبل العام 2005 إزاء واشنطن بالبارد، إن لم يكن بالمعادي، لا سيما انه كان قد رفض الموافقة على طلب واشنطن بدعم الكويت عسكرياً بعد غزو الرئيس العراقي صدام حسين لها. ولكن النظرة إلى عبدالله تغيّرت بعدما أصبح ملكاً، إذ يؤكد الأميركيون من خلال تعاونهم معه لسنوات طويلة، أن الملك كان مدركاً دائماً لأهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط بلاده بواشنطن.
ووسط المناخ السائد بشيخوخة المملكة، وعدم صمود ملوكها لفترات طويلة على العرش، انشغلت واشنطن بابتكار وسائل دبلوماسية تتيح لها أن تؤقلم سياساتها مع متغيّرات الخلافة الحاصلة والحدّ من حالة انعدام الاستقرار التي قد تنتج عنها. وقد تمّ اقتراح إجراءات تساعدها في الحفاظ على استقرار العلاقة الثنائية مع الرياض ومنها جدولة الزيارات الدبلوماسية، حيث تحدّد الزيارات إلى الرياض بشكل منتظم من قبل مسؤولين رفيعي المستوى بشكل يبقى أمراء المملكة على تماس دائم مع اهتمامات الولايات المتحدة وتوقعاتها في مجمل قضايا السياسة العامة. من جهة أخرى، قد يجدي نفعاً، وفقاً لبعض المشرعين الأميركيين، زيادة موظفي السفـارة في الرياض وفي قنصليتي جدة والظهران.
/ انتهى التقرير /