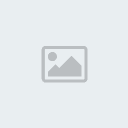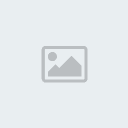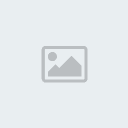عقيدة الشيعه في القضاء والقدر و في البداء و في أحكام الدين
10 - عقيدتنا في القضاء والقدر
ذهب قوم وهم ( المجبرة ) إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي وهو مع ذلك يعذبهم عليها ، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها ، لأنهم يقولون إن أفعالهم في الحقيقة أفعاله وإنما تنسب إليهم على سبيل التجوز لأنهم محلها ، ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سواه .
وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الأشياء إذ ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له ، ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك .
وذهب قوم آخرون وهم ( المفوضة ) إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها ، باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه ، وإن للموجودات أسبابها الخاصة وإن انتهت كلها إلى مسبب الأسباب والسبب الأول ، وهو الله تعالى . ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى من سلطانه ،
- ص 44 -
وأشرك غيره معه في الخلق .
واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين ، والطريق الوسط بين القولين ، الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام ، ففرط منهم قوم وأفرط آخرون . ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون .
وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم السلام وأقوالهم أن يحسب إن هذا القول ، وهو الأمر بين الأمرين ، من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين ، وقد سبقه إليه أئمتنا قبل عشرة قرون .
فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة : ( لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ) . ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه .
وخلاصته : إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية ، وهي تحت قدرتنا واختيارنا ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه ، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل ، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه ، بل له الخلق والحكم والأمر ، وهو قادر على كل شئ ومحيط بالعباد .
وعلى كل حال ، فعقيدتنا إن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى ، فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا إفراط ولا تفريط فذاك ، وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه لئلا يضل وتفسد عليه عقيدته ، لأنه من دقائق الأمور بل من أدق مباحث الفلسفة
- ص 45 -
التي لا يدركها إلا الأوحدي من الناس ولذا زلت به أقدام كثير من المتكلمين . فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي .
ويكفي أن يعتقد به الانسان على الإجمال إتباعا لقول الأئمة الأطهار من أنه أمر بين الأمرين ليس فيه جبر ولا تفويض . وليس هو من الأصول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق .
11 - عقيدتنا في البداء
البداء في الانسان : أن يبدو له رأي في الشئ لم يكن له ذلك الرأي سابقا ، بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه ، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به ، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله ، وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه .
والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى لأنه من الجهل والنقص وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الإمامية .
قال الصادق عليه السلام : ( من زعم أن الله تعالى بدا له في شئ بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم )
وقال أيضا ( من زعم أن الله بدا له في شئ ولم يعلمه أمس فأبرأ منه ) .
غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم ، كما ورد عن الصادق عليه السلام : ( ما بدا
- ص 46 -
لله في شئ كما بدا له في إسماعيل إبني ) ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق آل البيت ، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة .
والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) .
ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار ، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا ، مع سبق علمه تعالى بذلك ، كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أنه يذبحه ، فيكون
معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شئ كما ظهر له في إسماعيل ولده إذ اخترمه قبله ليعلم الناس أنه ليس بإمام ، وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده لأنه أكبر ولده . وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا ( ص ) ، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم .
12 - عقيدتنا في أحكام الدين
نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم . فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا ، وما فيه المفسدة البالغة نهى عنه ، وما فيه مصلحة راحجة ندبنا إليه . . .
- ص 47 -
وهكذا في باقي الأحكام وهذا من عدله ولطفه بعباده . ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم ، ولا يخلو شئ من الأشياء من حكم واقعي لله فيه وإن انسد علينا طريق علمه .
ونقول أيضا إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهي عما فيه المصلحة ، غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون : إن القبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به ، فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتيان .
وهذا قول مخالف للضرورة العقلية ، كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة . وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة وذلك لاستلزامه نسبة الجهل أو العجز إليه سبحانه . تعالى علوا كبيرا .
وللخلاصة : أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه ، بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف ، ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا ينهى جزافا وهو الغني عن عباده .
الشيخ محمد رضا المظفر