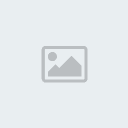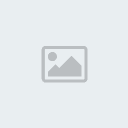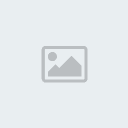موقف الإمام الحسين ( عليه السلام ) من معاوية بن أبي سفيان
للإمام الحسين ( عليه السلام ) في موقفه من معاوية صُورتان تَكامُليّتان ، وكلتاهما تحكيان مبدأيّته العصماء في لحاظ مصلحة الإسلام العليا :
الصورة الأولى :
التزامه ( عليه السلام ) بعهد أخيه الإمام الحسن ( عليه السلام ) ، ووفاؤه ببنود صلح أخيه المبرم مع معاوية بن أبي سفيان ، لاعتقاده ( عليه السلام ) بأن المصلحة الإسلامية لا زالت في ذلك .
ولأن مبادئ الإسلام وأحكامه تأبى عليه نقض العهود والتحلل من الوفاء بالعقود ، إلا إذا أُخلّ بشروطه أو انتهَت مُدّته ، وذلك لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ ) المائدة : 1 .
فلما استشهد الإمام الحسن ( عليه السلام ) تحرَّكت الشيعة بالعراق ، وكتبوا إلى الإمام الحسين ( عليه السلام ) في خلع معاوية والبيعة له ، فامتنع عليهم وذكر أن بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لا يجوز له نقضه حتى تمضي المدة ، فإن مات معاوية نظر في ذلك .
الصورة الثانية :
وفيها سلك الإمام الحسين ( عليه السلام ) مسلكاً تكامليّاً في مقابل التزامه بما تُملِيه عليه الحكمة الإلهية ، والمصلحة الإسلامية ، للصلح الذي عقده الإمام الحسن ( عليه السلام ) مع معاوية .
والتي من أبرزها كشف حقيقة حكومة بني أمية للمسلمين ، فانطلق الإمام ( عليه السلام ) من نفس هذه الحكمة الإلهية والمصلحة الإسلامية ، وعمل جهده لكشف هذه الحقيقة .
وهنا يتبيَّن لنا السر في عدم التخالف بين موقفه في الصورة الأولى وموقفه في هذه الصورة الثانية .
فهما صورتان لموقف تكاملي هادف ، يحفظ في الأولى حدود الصلح المُعلَنَة ، ويسعى في الثانية لتكميل تحقيق الأهداف المنشودة لهذا الصلح .
وذلك عن طريق إظهار الحق وإعلانه في وجه معاوية بن أبي سفيان ، والتصدِّي له بالحُجَّة البالغة ، وتَعرِية انحرافه عن كتاب الله وسُنَّة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، ودرء البدع التي أحدثها في الدين ، واستنكار الظلم والجور الذي أوقعه على صفوة الأصحاب والتابعين من شيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وسفك دمائهم الطاهرة خلافاً لبنود الصلح المبرم مع الإمام الحسن ( عليه السلام ) .
ومن هذه المواقف نذكر ما يلي :
الموقف الأول :
تصدِّيه ( عليه السلام ) لأمر معاوية وَوُلاَتِه وعُمَّاله بلعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على المنابر واضطهاد شيعته ، وكذلك قتل من يروي شيئاً من فضائله ( عليه السلام ) .
فعن سليم بن قيس قال : نادى منادي معاوية أن قد برئت الذمَّة ممن يروي حديثاً من مناقب علي ( عليه السلام ) وفضل أهل بيته ( عليهم السلام ) .
وكان أشدّ الناس بليَّة أهل الكوفة ، لكثرة من بها من الشيعة ، فاستعمل زياد بن أبيه ، وضمَّ إليه العراقيين الكوفة والبصرة ، فجعل يتتبَّع الشيعة وهو بهم عارف .
فكان يقتلهم تحت كل حجر ومدر ، فأخافهم وقطع الأيدي والأرجل ، وصلبهم في جذوع النخل ، وسمل أعينهم ، وطردهم وشرَّدهم حتى نُفوا عن العراق .
فلم يبقَ بها أحد معروف مشهور ، فهم بين مقتول أو مصلوب أو محبوس ، أو طريد أو شريد .
وكتب معاوية إلى جميع عُمَّاله في جميع الأمصار أن : لا تجيزوا لأحد من شيعة عليٍّ وأهل بيته شهادة ، وانظروا قبلكم من شيعة عثمان ومحبِّيه ، ومحبِّي أهل بيته وأهل ولايته ، والذين يروون فضله ومناقبه ، فادنُوا مجالسهم ، وقرّبوهم وأكرِموهم ، واكتبوا بمن يروي من مناقبه واسم أبيه وقبيلته .
ففعلوا حتى كثرت الرواية في عثمان ، وافتعلوها لما كان يبعث إليهم من الصلات والخِلَع والقطائع من العرب والموالي .
فكثر ذلك في كل مِصر ، وتنافسوا في الأموال والدنيا ، فليس أحد يجيء من مصر من الأمصار فيروي في عثمان منقبة أو فضيلة إلا كُتب اسمه وأُجيز ، فلبثوا بذلك ما شاء الله .
ثم كتب إلى عُمَّاله أنَّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر ، فادعوا الناس إلى الرواية في معاوية وفضله وسوابقه ، فإن ذلك أحبُّ إلينا وأقرُّ لأعيُنِنا ، وأدحضُ لحُجَّة أهل البيت وأشَدُّ عليهم .
وكان أشدُّ الناس في ذلك القُرَّاء المراؤون ، والمُتَصنِّعون ، الذين يُظهرون الخشوع والورع ، فكذبوا وانتحلوا الأحاديث وَوَلَّدوها .
فحظوا بذلك عند الوُلاة والقُضَاة وأُدنُوا مجالسهم ، وأصابوا الأموال والقطائع والمنازل ، حتى صارت أحاديثهم ورواياتهم عندهم حقّاً وصدقاً ، فَرَوَوْهَا وقَبلُوها وتعلَّموها وعلّموها ، وأحبّوا عليها وأبغضوا مَنْ ردّها أو شَكَّ فيها .
إذن ، فلما استشهد الإمام الحسن ( عليه السلام ) ازداد البلاء وَكَثُرَت الفتنة ، فلم يبقَ لله ولي إلا هو خائف على نفسه ، أو مقتول ، أو طريد شريد .
فلما كان قبل موت معاوية بسنتين ، حجَّ الإمام الحسين ( عليه السلام ) وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس معه .
وقد جمع الإمام الحسين ( عليه السلام ) بني هاشم ، وشيعته ، من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والتابعين ، بمنىً وهم أكثر من ألف رجلا ، فقام فيهم خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال ( عليه السلام ) : ( أمَّا بَعد ، فإن الطاغية قد صَنعَ بنا وبشيعتِنا ما قد عَلِمتُم ورأيتم وشَهِدتُم وَبَلَغَكُم ، وإنِّي أريدُ أن أسألَكُم عن أشياء ، فإن صَدَقتُ فَصدّقُونِي ، وإن كَذبتُ فَكَذِّبُوني .
إسمعوا مَقَالَتِي ، واكتُمُوا قولي ، ثم ارجِعُوا إلى أَمصَارِكُم وقبائلكم ، مَن أَمِنتُمُوهُ وَوَثِقتُم به فادعوهُم إلى ما تَعلَمُون ، فإني أخافُ أن يَندَرِسَ هذا الحق ويذهب ، ( والله مُتِمُّ نورِهِ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَ ) ) الصف : 8 .
فما ترك الإمام الحسين ( عليه السلام ) شيئاً أنزله الله فيهم أهل البيت ( عليهم السلام ) من القرآن إلا قاله وفَسَّره ، ولا شيئاً قاله الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في أبيه وأمِّه وأهل بيته ( عليهم السلام ) إلا رواه .
وفي كل ذلك يقول الصحابة : اللَّهُمَّ نَعَم ، قد سمعناه وشهدناه ، ويقول التابعون : اللهم قد حدّثَنَا مَن نُصدقه ونأتَمنُه ، حتى لم يترك شيئاً إلا قاله .
ثم قال ( عليه السلام ) : ( أُنشِدُكُم بِاللهِ إلاَّ رَجِعتُم وَحَدّثتُم بِهِ مَن تَثِقُونَ به ) .
ثم نزل ( عليه السلام ) وتفرَّق الناس على ذلك .
الموقف الثاني :
استنكاره ( عليه السلام ) على معاوية قَتلَهُ لِصَفوَةِ من صحابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتابعيهم من شيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
فكتب الإمام الحسين ( عليه السلام ) إلى معاوية : ( … أَلَستَ قاتلَ حِجرَ بن عَدي أخي كندة ، وأصحابه الصَّالِحِين المُطِيعِين العَابِدين ؟!! ، كانوا ينكرون الظلم ، ويَستعظِمُون المُنكَر والبدع ، وَيُؤثِرُون حُكمَ الكِتاب ، ولا يخافون في الله لَومَةَ لاَئمٍ .
فقتلتَهُم ظلماً وعدواناً ، بعد ما كُنتَ أعطيتَهُم الأَيمان المغلَّظَة والمواثيقِ المُؤَكَّدة ، لا تأخذهم بِحَدَثٍ كان بينك وبينهم ، ولا بإحنة تَجِدَها في صدرك عليهم .
أَوَلَستَ قاتل عمرو بن الحمق صاحب رَسُولِ اللهِ ؟!! ، العبدِ الصالح الذي أبلَتْهُ العبادة فَصَفَّرتَ لَونَهُ وَنَحَّلتَ جِسمَهُ بعد أن أَمَّنتَهُ وأعطيتَهُ من عهود الله عزَّ وجلَّ وميثاقه ما لو أعطيتَهُ العُصم فَفَهِمتْهُ لَنَزَلَتْ إِليكَ مِن شغفِ الجِبَال ، ثم قتلتهُ جُرأَةً على الله عزَّ وجلَّ واستخفافاً بذلك العهد …
أَبشِرْ يا معاوية بِقِصَاصٍ ، واستَعِدْ للحساب ، واعلَمْ أنَّ للهَ عزَّ وجلَّ كتاباً لا يُغَادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلاَّ أحصاها ، وليسَ اللهُ تبارك وتعالى بِنَاسٍ أخذَكَ بالظِّنة ، وَقَتلَكَ أولياءه بالتُّهمة ، وَنَفْيَكَ إيَّاهم من دار الهجرة إلى الغُربَة والوَحشَة …
لا أَعْلَمُكَ إلاَّ قَد خَمَّرتَ نفسَك ، وَشَريتَ دينَكَ ، وغَشَشْتَ رعيّتك ، وأخزَيتَ أمانَتَك ، وَسَمِعتَ مقالةَ السَّفِيهِ الجاهلِ ، وأَخفْتَ التقيَّ الوَرِعَ الحَلِيم ) .
الموقف الثالث :
إظهاره ( عليه السلام ) وإعلانه لفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) وحقهم في ولاية المسلمين .
فعن موسى بن عقبة أنه قال : لقد قيل لمعاوية : إنَّ الناس قد رَمَوا أبصارَهم إلى الحسين ، فلو قد أمرته يصعد المنبر ويخطب ، فإن فيه حصراً أو في لسانه كلالة .
فقال لهم معاوية : قد ظننَّا ذلك بالحسن ، فلم يزل حتى عَظُمَ في أعين الناس وفَضَحَنا .
فلم يزالوا به حتى قال للحسين ( عليه السلام ) : يا أبا عبد الله ، لو صعدت المنبر فخطبت .
فصعد الإمام الحسين ( عليه السلام ) المنبر ، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه وصلى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسمع رجلاً يقول : من هذا الذي يخطب ؟
فقال ( عليه السلام ) : ( نحن حزب الله الغالبون ، وعترة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأَقربُون ، وأهل بَيتِه الطيِّبُون ، وأَحَدُ الثَّقلين الذين جَعَلَنا رسولُ الله ( صلى الله عليه وآله ) ثاني كتاب الله تبارك وتعالى ، الذي فيه تَفصيلُ كُلِّ شيء ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفِه ، والمُعوَّلُ علينا في تفسيره لا يبطينا تأويله ، بَل نَتَّبع حَقَايِقَه ، فأطيعونا فإنَّ طاعتَنَا مفروضة إن كانت بطاعةِ الله ورسولِهِ مقرونة …
وأُحذرُكم الإصغاء إلى هتوفِ الشيطان بكم ، فإنَّه لكم عدوٌّ مبين ، فتكونوا كأوليائه الذين قال لهم : لا غالب لكم اليومَ من النَّاس وإنِّي جارٌ لكم .
فلما تراءت الفئتان نَكَصَ على عَقِبَيهِ وقال : إنِّي بريءٌ منكم ، فَتلقون للسيوف ضرباً وللرِّماح ورداً وللعمد حطماً وللسِّهام غرضاً ، ثم لا يُقبَلُ من نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ) .
منقول
تحياتي واحترامي لكم جميعا